وسط الناس - محليات » اليوم السابع » محمد مصطفى سالم يكتب: صناعة تشتيت الوعي

لا أكتب هذا المقال من موقع الباحث السياسي، بل من موقع الشاب العربي الذي يراقب بقلقٍ حقيقي حالة ارتباك ذهني غير مسبوقة يعيشها جيله. فملامح التشويش لم تعد خافية، بل انعكست بوضوح على سلوكيات قطاعات واسعة من الشباب؛ حيث نشهد شابًا تجاوز العشرين من عمره، لكنه يتصرف بعقلية طفولية، في وقت كان فيه الشاب في العمر ذاته لدى الأجيال السابقة يتحمّل مسؤوليات العمل والأسرة ويخوض معترك الحياة بجدية أكبر.
وهنا يفرض السؤال نفسه بإلحاح: كيف جرى تفريغ الشباب من أدواتهم النفسية والفكرية، حتى بدوا أكثر هشاشة من أقرانهم في مجتمعات أخرى؟ وهل ما نعيشه اليوم نتاج تطور اجتماعي طبيعي، أم ثمرة عملية تفكيك ممنهجة؟
في تقديري، ما يحدث هو تشتيت مقصود ومدروس، بدأ مع الترويج لمفهوم «المراهقة» باعتباره مرحلة ممتدة من اللا مسؤولية، وكأن النضج مسألة زمنية بحتة لا علاقة لها بالوعي أو بالبيئة المحيطة. غير أن الوعي الإنساني لا ينفصل عن سياقه؛ فالطفل الذي ينشأ وسط الخطر والصراع لا يمكن أن تتشكل رؤيته للعالم بالطريقة نفسها التي تتشكل بها رؤية طفل يعيش في بيئة آمنة ومرفهة.
ويزخر التاريخ، قديمه وحديثه، بأمثلة دامغة تؤكد أن الشباب كانوا دائمًا في قلب التحولات الكبرى. فقد فتح محمد الفاتح القسطنطينية وهو في الحادية والعشرين من عمره، وقاد الإسكندر الأكبر جيوشه في سن مبكرة، وفي التاريخ المصري الحديث شكّل الضباط الأحرار نواة التغيير، وكان أكبرهم سنًا لا يتجاوز منتصف الثلاثينيات.
ومن هذا السياق، يمكن فهم الغاية الأساسية من هذا التشتيت، وهي إنتاج أجيال منزوعة الانتماء، ضعيفة الثقة بالذات، مضطربة الهوية، ومفتقرة إلى البوصلة الفكرية. وقد تحقق ذلك عبر مسارات متداخلة، من أبرزها:
أولًا: اختزال الطموح في الاستهلاك
حيث جرى تحويل قطاعات واسعة من الشباب إلى مجرد مستهلكين، تُختزل طموحاتهم في امتلاك أحدث هاتف، أو ارتداء علامة تجارية شهيرة، أو اقتناء سيارة فارهة، بدل السعي إلى بناء الذات أو التأثير في المجتمع.
ثانيًا: إفراغ السياسة من معناها
تمت شيطنة الاهتمام بالشأن العام، وتصوير السياسة بوصفها مضيعة للوقت، فغاب الوعي النقدي، وحلّت محله الشعارات السطحية، ما جعل الشباب أكثر قابلية للتوظيف والتوجيه دون إدراك حقيقي لطبيعة الصراعات المحيطة بهم.
ثالثًا: تفكيك الهوية الجامعة
رُوّجت سرديات تعتبر الهوية الوطنية والدينية عبئًا تاريخيًا يجب التخلص منه، ما أفضى إلى شعور بالدونية الحضارية، ورغبة في التشبه بالآخر بدل منافسته أو الندية معه. وحتى منظومات التعليم، في كثير من الأحيان، باتت منزوعة السياق المحلي، مستوردة في فلسفتها وأهدافها.
رابعًا: هيمنة ثقافة «الترند»
وهي من أخطر أدوات التشتيت، إذ أصبح أي محتوى، مهما بلغ من السطحية أو تعارض مع القيم المجتمعية، قادرًا على الانتشار الكاسح، بما يحوّل اللحظة العابرة إلى معيار للوعي والاهتمام. وفي هذا السياق، يصبح الثبات على القيم تحديًا بالغ الصعوبة، كما عبّر عن ذلك الحديث النبوي الشريف:
«يأتي على الناس زمان، القابض على دينه كالقابض على الجمر».
خامسًا: صناعة القدوة الزائفة
عبر إبراز شخصيات خالية من القيمة المعرفية أو الأخلاقية، ومنحها المنصات والمال، في مقابل تهميش النماذج الجادة وتصويرها باعتبارها غير ملهمة أو غير صالحة للاقتداء.
وفي مقابل هذا المشهد القاتم، لا يمكن إغفال الجهود التي تبذلها الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإعادة الاعتبار لدور الشباب، من خلال فتح مسارات للمشاركة، والتأهيل، والاندماج داخل مؤسسات الدولة، بما يعيد بناء الثقة ويمنح الأمل في استعادة الدور الحقيقي للأجيال الجديدة.
وفي الختام، يواجه جيلنا، جيل (Z)، تحديًا مصيريًا في زمن تتسارع فيه الأزمات والحروب والتحولات الكبرى. ولم تعد المسألة ترفًا فكريًا أو خيارًا مؤجلًا، بل أصبحت خيارًا وجوديًا:
إما أن نكون شركاء واعين في حماية أوطاننا وبنائها، أو نتحول، دون وعي، إلى أدوات تُستخدم ضدها.
بتاريخ: 2026-01-30




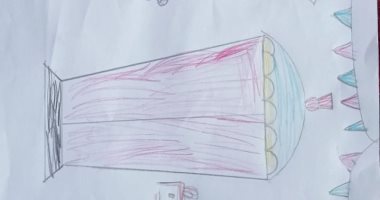
يمنع أي لفظ يسيء للذات الالهية أو لأي دين كان أو طائفة أو جنسية.
جميع التعليقات يجب أن تكون باللغة العربية.
يمنع التعليق بألفاظ مسيئة.
الرجاء عدم الدخول بأي مناقشات سياسية.
سيتم حذف التعليقات التي تحوي إعلانات.
التعليقات ليست للتواصل مع إدارة الموقع أو المشرفين. للتواصل يرجى استخدام صفحة اتصل بنا.